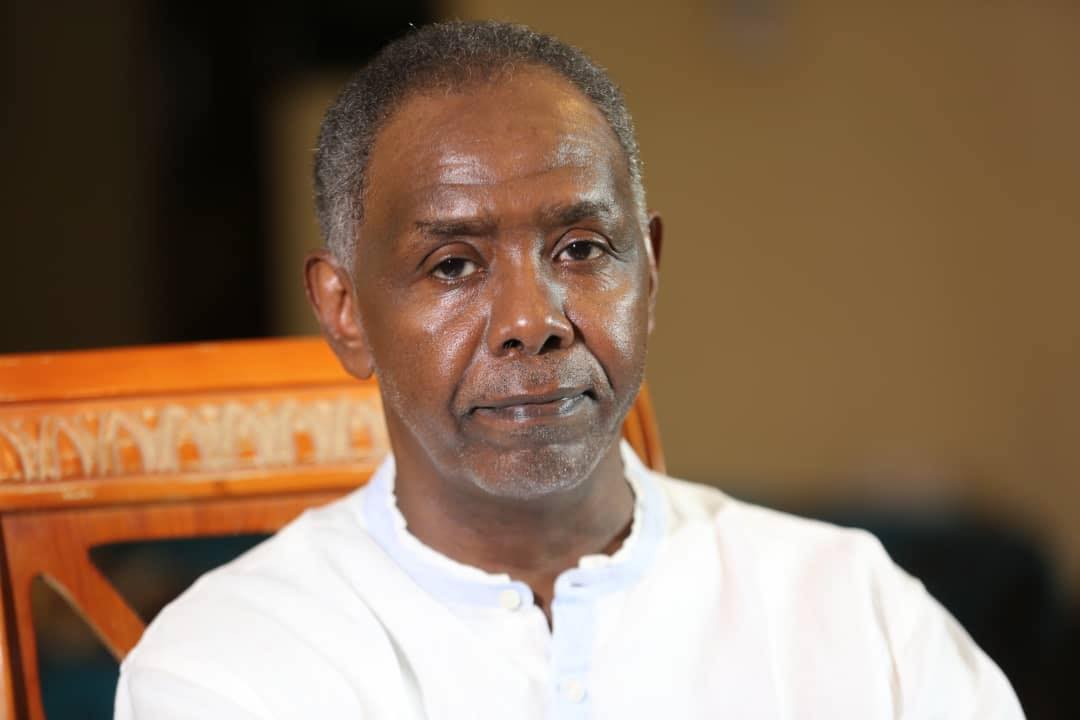س 1: يحتفل السودان بعد أيام، بالذكرى الـ 60 لاستقلاله، أين يقف من شعار “الاستقلال نهاية تاريخ، وبداية مستقبل”؟
ج 1: أودُّ – توخِّياً للدقَّة، واعتماداً على النتائج الموضوعية لحالة السودان – أن أقترح تعديل هذا الشعار إلى: “الاستقلال: نهاية مرحلة وبداية مرحلة”. فالصيغة التي تفضَّلتَ بها قد تتضمَّن وقوع نُمُوَّ أو تطوُّر اضطلعت وتضطلع به “الدولة المستقِلَّة” (السودان في هذه الحالة) لتتبيَّن آثاره الإيجابية على المجتمع؛ وهو ما أرى أنه لم يحدث. بل أزعم أن الذي حدث – على أكثر من صعيد – هو العكس. فإذا كان المعنى أو المحتوى النموذجي لمفهوم الاستقلال، بمعنى استقلال الارادة السياسية والاقتصادية والثقافية لصالح البناء والانماء المحليين، فإن هذا لم يتحقق على أي مستوى. وحتى مستوى تغيير السلطة، أي انتقالها من حكم المستعمر المباشر إلى حكم القيادات السياسية المحلية، لم يتم إلَّا على مستوىً شكليٍّ؛ حيث أن من خَلَفَ الاستعمار، من القيادات “الاستقلالية”، الشمالية المركزية، لم يكونوا سوى وكلائه المحليين. فالمعروف – على نحو عام في الكثير من حالات المستعمرات “السابقة” للاستعمار الغربي، بما في ذلك حالة السودان – أن الادارة الاستعمارية قد أعدَّت فئة من القيادات المحلية لتستلم السلطة بعد خروجها. ولنا في التقرير الذي أعدَّته واعتمدته الادارة الاستعمارية البريطانية في السودان – عقب إسقاط الدولة المهدية – أحد الشواهد المبكِّرة على إحدى الاستراتيجيات – بعيدة المدى – التي ابتكرتها تلك الادارة للمحافظة على مصالحها في السودان – إنْ هي أُضُطرَّت يوماً للتخلِّي عن حكمه المباشر (وهي التي كانت وقتها في عنفوان جبروتها وبداية مرحلة توطيد سيطرتها في السودان؛ أي أن نشوة انتصارها على المهدية لم تُنْسِها أن تتحسَّب للمستقبل). في ذلك التقرير وردت توصية يقول معناها إنه يتوجَّب على الادارة البريطانية في السودان أن “تعتني” بأبناء مفجِّر الثورة المهدية والمُرسي الأول لدعائم دولتها، الإمام محمد أحمد المهدي، عبر عدَّة وسائل من بينها تمكينهم من خلق الثروة ومساعدتهم على تنميتها والاستغراق في الرفاه الناتج عنها لكي يُنسيهم ذلك التبنِّي العملي للتعاليم الرادكالية للأب الروحي للثورة والدولة المهدية. طبعاً لاحقاً أُضيفَت الإستراتيجية الثقافية التي تتمثَّل – من بين ما تتمثَّل – في المِنَح التعليمية والتدريب الثقافي والتقني الذي سيعزِّز من النفوذ الطبقي لتلك الفئة. وقد نجحت هذه الاستراتيجيات – وغيرها – أيَّما نجاح، ربما فاق تصوُّر المستعمِر. أمَّا الأنظمة السياسية السودانية، الشمالية المركزية – مدنية كانت أم عسكرية – التى توالت على السلطة، فإن تبعيَّتها للغرب – من بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأميركية – لهي أكثر من ملموسة. ربَّما تتشدَّق الأنظمة المدنية بأنها كانت “مستقِلَّة”. قد يكون هذا صحيح نظرياً. بيد أن حكومات تلك الأنظمة – وهي التي كانت تتمتَّع بقيادة يمينية بامتياز (وبعضها سليل “العناية” البريطانية طبعاً) – ما كان لها أن تخالف المحدِّدات الاقتصادية والسياسية الغربية، ربَّما فيما عدا الموقف من إسرائيل في ذلك الوقت. أمَّا فيما يتعلَّق بالأنظمة العسكرية، فلعله قد يكفي شاهداً أو مثالاً أن من العوامل التي فاقمت سخط الشارع السوداني على نظام الفريق إبراهيم عبُّود (1958– 1964) وساهمت، بالتالي، في إشعال ثورة أكتوبر 1964 التي أطاحت به كانت تتمثَّل في قبول ذلك النظام للمعونة الأميركية. وكذلك فإن تبعية نظام المشير جعفر نميري (1969 – 1985) للغرب عموماً – ولأميركا على نحوٍ خاص – فقد كانت تفوق تبعية سلفه على مستويي الكم والكيف. على أن أحد تأثيراتها البارزة كانت تتمثَّل – أيضاً – في مضاعفة غضب الشارع السوداني على ذلك النظام إذ كانت من الأسباب الفاعلة في الثورة عليه وإسقاطه عبر انتفاضة مارس-أبريل 1985. أما النظام العسكري الراهن، فهو – وإن كان لا يحظى بالدعم العلني لقوى الاستعمار الجديد – إلَّا أنه مرغوب من قِبَلها – لقابليته وأمنياته أن يغدو تابعاً (بوضوح) أكثر من الأنظمة المدنية، وذلك بعد أن تخلَّى عن أوهامه الآيديولوجية وشططه السياسي (من وجهة نظر الاستعمار الجديد). وسبب تفضيل قوى الاستعمار الجديد للتعامل مع حلفاء عسكريين على الحلفاء المدنيين (لاسيَّما في السودان) يكمن في أن الأنظمة المدنية-الديموقراطية – رغم ولاء قياداتها التقليدية له – تسمح بالمساءلة السياسية العامة؛ وبالتالي فهي تسمح بتجييش الرأي العام – لا سيَّما من قِبَل الأقليَّات المعارِضة، خصوصاً قوى اليسار – ضد ما يبدو – مثلاً – أنه مسٌّ بالسيادة الوطنية. أما قيادات الأنظمة العسكرية فليس هناك من يساءلها (غير رؤسائها المستعمِرين الجُدد طبعاً).
غير أنه من الثابت أن جميع الأنظمة السياسية، الشمالية المركزية، التي تعاقبت على السلطة في السودان – بعد الخروج المباشر للمستعمر – ساهمت في التدهور المضطرد للواقع العام فيه. حتى الكثير من البنيات الاقتصادية – إن لم يكن كلها – التي أنشأها المستعمر لأجل مصلحته هو بالأساس – ليس لم يتم تطويرها فحسب، بل لم تتم المحافظة عليها كما هي. خُذْ – مثلاً فحسب – مشروع الجزيرة، هذا الذي جعل السودان أحد أهمَّ مصدِّري (إن لم يكن أهمَّ مصدِّر على الاطلاق) للقطن طويل التيلة في العالم، وقل لي أين هو الآن؟ خُذْ – مثلاً فحسب – مشاريع تصدير الصمغ العربي، السمسم، الفول السوداني، الماشية وقل لي أين هي الآن؟ خُذْ – مثلاً فحسب – شبكة الموصلات العامة متمثِّلة في خطوط السكة حديد وخطوط الترام، وقل لي أين هي الآن؟ أمأ إذا نظرت إلى واقع الخدمات الصحية، التعليمية، الاجتماعية والثقافية – على نحو عام – فحدِّث ولا حرَج كما نقول. إن جميع هذه البنيات – وغيرها طبعاً – لم تنهار الآن، أي في عهد هذا الحكم، وإنما ظلَّلت تتآكل خلال حكم جميع الأنظمة السودانية، الشمالية المركزية (وإن كان معدَّل التدهور في عهد النظام الراهن أسرع بكثير من عهود الأنظمة التي سبقته).
فهل – بعد هذا – يمكن القول إن خروج المستعمر كان ايذاناً ببداية مستقبل للسودان؟ نظرياً، كان هذا ما يجب أن يكون. عملياً، ما حدث هو أن الاستقلال كان بداية عهود من قمع سياسي داخلي، ذي درجات وأشكال مختلفة من نظام إلى آخر، وأنماط متباينة من التدهور السياسي، الاقتصادي والاجتماعي.
س 2: لأكثر من نصف قرن، يتقلب السودان بين ثنائية متلازمة، ثورة شعبية تقضي على حكم عسكري، يعقبه انقلاب عسكري ينقضُّ على حكم ديمقراطي، برأيك ما أسباب هذه اللازمة الثنائية في السودان الحديث؟
ج 2: السبب يكمن – برأيي – في هشاشة البنية السياسية السودانية على نحو عام. فالسلطات السودانية، الشمالية المركزية، التي أعقبت الخروج المباشر للمستعمر لم تقم بتشييد بنية سياسية راسخة. والسبب يعود إلى إفتقار قيادات هذه السلطات للأُسس الوجدانية-الأخلاقية-الفكرية-الثقافية-السياسية الَّلازمة لمثل هذا التشييد. كما أن البنيات العامة، تلك التي يكون من شأنها المساهمة في توليد وترسيخ بنية سياسية عامة مثل النهضات الثقافية، الفكرية، العلمية، الأخلاقية والسياسية (أو أسس الحداثة بصورة عامة) بعضها كان بالغ الضمور وبعضها لم يكن موجوداً (وما يزال غير موجود). كان هذا هو حال النُّخَب السياسية التي آلت إليها السلطة بعد الاستقلال. أما الأنظمة السياسية الأخرى التي تعاقبت على السلطة في السودان بعد ذلك، فقد ورثت نُخَبها نفس الافتقار لتلك الأُسس لتظل البنية السياسية تعاني من نفس الهشاشة. في بلدان كبريطانيا، فرنسا، ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية – مثلاً – ليس من الوارد حدوث إنقلاب عسكري لأن البنية السياسية العامة في هذه البلدان راسخة بسبب وفرة ونمو البنيات التي شيَّدت ورسخَّت أنظمتها. أما في سوداننا المعاصر (وليس الحديث)، فإن “التغيير الرَّادِكالي الشكلي” للأنظمة سهلٌ: نظام مدني، فعسكري، فمدني، فعسكري…وهكذا.. بسبب هشاشة البنية السياسية العامة. إذن، نحن في حاجة إلى البنيات أو الأُسس الحديثة – المتوازية والمتواشجة في نفس الوقت – التي تمكَّن من إحداث تغيير رادكالي حقيقي، هذا الذي يقود إلى بناء وترسيخ نظام سياسي مدني ديموقراطي (دعنا نأمل أن يكون منظوره للعدالة الاجتماعية أكثر تطوراً من المنظورات الغربية). ولن يصبح هذا ممكناً دون ثورة ثقافية أصيلة.
س 3: استقراء لوقائع ستة عقود، هناك من يرى، أن السودان بحاجة ماسة إلى إعادة صياغة الانسان السوداني أولا، هل تتفق أو تختلف مع هذا الرأي؟ ولماذ؟
 سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم