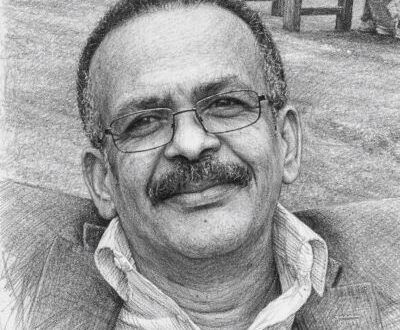دكتور محمد عبدالله
muhammedbabiker@aol.co.uk
لم تكن قضية جيفري إبستين فضيحة جنسية عابرة تضاف إلى سجل الفضائح الأمريكية، بل كانت زلزالا هز أركان العلاقة بين المال والسلطة والعدالة. كشفت القضية عن تعفن يسكن قلب النخب، لا هامش المجتمع.
ولد إبستين في بروكلين في ظروف عادية، ثم تسلل إلى عالم المال حيث نسج ثروة غامضة المصادر. وفي سنوات قليلة تحول إلى ظاهرة: قصور فاخرة، طائرة خاصة، جزيرة معزولة، وهالة من العلاقات مع رؤساء سابقين وأمراء ومليارديرات وعلماء ومشاهير. بدا في عيون كثيرين رمزا للنجاح.
لكن خلف هذه الواجهة المصقولة كانت حكاية أخرى تحكى همسا. حكاية فتيات قاصرات تحدثن عن استغلال منظم. تحولت الهمسات إلى ملفات قضائية، لكنها اختنقت سريعا بتسويات مريبة وعقوبات مخففة. بدت العدالة الأمريكية، التي تتغنى بصرامتها، وكأنها تغمض عينيها عندما يتعلق الأمر بالثراء والنفوذ.
انفجر المشهد عام 2019 حين ألقي القبض على إبستين مجددا بتهم الاتجار الجنسي بالقاصرات. هذه المرة كان الضوء مسلطا، والإعلام حاضرا، والغضب شعبيا عاما. ثم جاءت المفارقة القاتمة: موته في زنزانته في ظروف أعلنت انتحارا، لكنها تركت وراءها أسئلة لا تنتهي. هل انتحر الرجل؟ أم أغلق ملف شبكة كاملة؟
ما يستوقف المراقب في رد الفعل الأمريكي ليس الغضب ذاته، بل طبيعته الانتقائية. فمجتمع تجاوز منذ زمن طويل كثيرا من المحرمات الجنسية، لم يثر بهذا الحجم إلا عندما دخل عنصر القاصرات إلى قلب القضية. عندها فقط تصاعدت مفردات الوحشية والشر المطلق. وهو ما يطرح سؤالا مزعجا: هل كان سيكون للجريمة الوقع نفسه لو كان الضحايا بالغين؟ وهل كانت الأخلاق العامة تصطدم بالفعل أم لأن القضية تمس الفئة الوحيدة التي ما زالت تحظى بإجماع واسع على براءتها؟
وزاد من حدة الصدمة أن المشتبه بهم ليسوا من هوامش المجتمع، بل من قمته: سياسيون يسنون القوانين، وممولون يتحكمون في المسار الانتخابي، ومشاهير يقدمون بوصفهم نماذج للنجاح. كأن القضية قالت للمجتمع الأمريكي إن الشر لا يسكن الأزقة المظلمة وحدها، بل يسكن القصور المضيئة أيضا.
في المجتمعات العربية والإسلامية جاء التلقي بدوره متباينا. رأى فيه البعض دليلا جديدا على ما يصفونه بانحلال الغرب، فانطلقوا يرسمون صورة كاريكاتيرية لمجتمع بلا قيم. واستثمره آخرون لتصفية حسابات مع الليبرالية والفكر الغربي برمته. بينما دعا فريق ثالث إلى تحصين المجتمعات والتمسك الصارم بالتقاليد خشية الانزلاق.
غير أن هذه القراءات، على اختلافها، تشترك في قدر كبير من التبسيط. فهي تفترض أن الانحراف نتاج ثقافة بعينها، أو أن الحرية تقود حتما إلى الفساد، أو أن المجتمعات تستطيع أن تعيش خلف أسوار أخلاقية مغلقة.
والواقع أكثر تعقيدا من ذلك بكثير.
نحن نعيش في زمن العولمة والاتصال المفتوح، حيث تعبر الأفكار والصور وأنماط العيش القارات في ثوان. لم يعد ممكنا استيراد التكنولوجيا ورفض التحولات الثقافية التي تصاحبها. ولم يعد مقنعا الادعاء بأن مجتمعاتنا محصنة بطبيعتها ضد آفات الاستغلال والفساد.
التحصين الحقيقي لا يكون بالإنكار ولا بالشعارات، بل ببناء وعي نقدي، وبأنظمة قانونية عادلة لا تميز بين غني وفقير، وبثقافة مجتمعية تحمي الضعفاء وتخضع الأقوياء للمساءلة، أيّا كانت أسماؤهم أو مناصبهم.
قصة إبستين، في جوهرها، ليست حكاية رجل منحرف فحسب، بل قصة نظام يسمح للثروة بشراء الصمت، وللنفوذ بشراء الحصانة، وللضحايا بالبقاء في الظل سنوات طويلة.
ولهذا فهي لا تخص أمريكا وحدها. إنها مرآة مرفوعة أمام كل مجتمع. وكل من ينظر فيها يرى انعكاسا لواقعه، بدرجة أو بأخرى.
إنها ليست حكاية عن الغرب بقدر ما هي حكاية عن الإنسان، حين تتحرر القيود الخارجية، ولا تحل محلها قيم داخلية راسخة.
 سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم